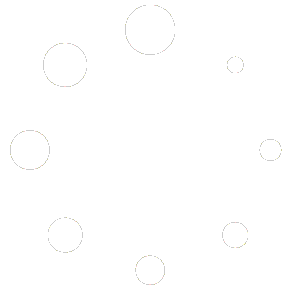أنا سمر، في البيت ينادونني تهكماً: “قطفة الحبق الدبلانة”، أو”النوّاية” لسرعة بكائي أمام أي موقف بصوت هسيس يشبه مواء القطة…. نحن الجيل الذي نشأ وكبر تحت وطأة الحرب، خضنا تجارب شغفنا تحت القصف، لم نعدمه ولكن بهت لونه كثيراً.
كنت في أواسط مرحلة التعليم الأساسي حين بدأت الحرب، ومن حينها بدأت أشعر أن العالم أكبر بكثير مما يحتمله قلب صغير مثل قلبي.
قبل الحرب، كنا في البيت أسرة سعيدة، لسنا ميسوري الحال، ولكن كان والدي يحرص أن يلبي كل طلباتنا وخاصة من أجل تعليمنا، كان شديد التأثر والحسرة، لأنه ترك مدرسته باكراً ليساعد والده، فهو وحيده.
بالنسبة لي، وأنا طفلة في هذه المرحلة الدراسية الحساسة، كنت ألجأ إلى كتابة بعض الكلمات الصغيرة، تشبه نوعاً ما دواء وصفه لنا الطبيب للتخفيف من آلامنا، أجد فيها متعتي وسكينتي، ومتنفسي من كل شعور سيء.

سأروي لكم هذه الحادثة:
في الصف الثالث الابتدائي، قرّرت معلمة الصف معاقبة كل طالبة لا تأتي بدفتر جديد، والعقاب لدى تلك المعلمة يعني إذلال نفسي وألم جسدي، ولم أكن أمتلكه، فقد كنت أكتب بدفتر أخي الذي يسبقني بسنتين، مرت المعلمة على الطالبات، وحين وصلت عندي، ولما لم تجد لدي الدفتر الجديد، قالت لي: اخرجي برا الصف و” بوجهك إلى الإدارة “.
تنفست الراحة لأن هذه العقوبة أهون عليّ من أن توقفني بإذلال أمام الطالبات زميلاتي، وأصبح فرجتهن، ومحط أنظارهن، وشفقتهن أو تنمرهن. امتلكت الشجاعة والتمرد – وهذا ليس من طبعي – ولم أذهب إلى الإدارة، بل ذهبت إلى (دورة مياه الطالبات – الحمامات )، في الناحية الأخرى، وقفت أمام صنبورالماء، اغطي وجهي بيدي، كنت سأبكي، لكني لم أفعل، غسلت وجهي، ثم نشفته بأكمامي وعدت إلى قاعة الصف، دخلت ونظرت في وجه المعلمة، قلت لها:
(يا آنسة، أنت آنسة والمهم أنك تدرسّينا، ونحن المهم أن نكتب ولو كان على كرتونة).
كانت الدموع تملأ عيني، ولكن لم أبكِ، وسمحت لي بالعودة إلى مكاني، وطوال الوقت وهي تحدق بي، كنت في تلك اللحظة أود أن أبكي، وفي نفس الوقت أشعر بسخط وحنق تجاه والدي، ولم ابكِ، وكان ذلك أول وأعظم بكاء مؤجل لي.
امسكت القلم وكتبت في رأس الصفحة ” أحب أبي، أبي رجل طيب” انتهى حنقي وغضبي منه، كانت تلك جملتي الأولى في الكتابة، تلك كانت الحضن الذي احتضن قهر طالبة صغيرة، هذه الحروف كانت ملائكة حلقت معي عالياً في عالم جميل.” أبي رجل طيب ” صفعة هويت بها على نفسي التي سخطت وتمادت، وكانت نوعاً من التهذيب والعلاج النفسي لي.

جاءت سنين الحرب وتدهور معها وضعي ومستواي الدراسي. بيتي لم يعد ملاذي الذي أدخله وانسكب به وأقذف خارجه هول ما عانيته بعيداً عنه، بات يتصدع كما تتصدع جدران المدن في زمن الحرب، بات يعرف الشجار أكثر مما يعرف السكينة، وبسبب توقف والدي عن العمل وتردي وضعه المادي وبالتالي عجزه عن توفير حاجات البيت والأولاد، دوماً كان يعلو صراخ أبي وأمي، وكأن صوتهما يمتد فوق كل ما أحاول فهمه من الحياة، بينما في الليل كنت أستيقظ على دوي يشبه المطرقة تهوي على رأسي، ومع كل قذيفة تسقط قريباً أو بعيداً، كان شيئاً من براءتي تسقط معها.
أحاول فتح كتبي ودفاتري على ضوء خافت خجول، ولكن كل صوت خارجي يتحول في رأسي إلى سؤال أكبر من أي امتحان: ” هل سنعيش غداً؟”
كيف يمكن لطفلة تحمل هذا السؤال أن تحفظ جدول الضرب؟ أو أن تفهم أين تقع عاصمة دولة، وهي لم تعد تؤمن أن للبلدان عواصم مستقرة؟
في قاعة الصف كنت أجلس في آخره متوارية كعصفور حلق في حيز لا يصلح للطيران، أسند خدي على يدي وعيني على السبورة، وكأنها جدار تتكسر عليه محاولاتي كلها للفهم، وكانت المعلمة تتكلم وأنا أتابع فقط حركة شفتيها، وأشعر أن شيئاً في داخلي يغلق، باباً صغيراً يُقفل من تلقاء نفسه كلّما حاولت التركيز….هناك ضجيج يتقدم عليّ.. ضجيج لا يسمعه أحد سواي.
” قومي يا سمر، أعيدي ما شرحته”، يرتفع صوت المعلمة كصفعة في الهواء. أقف ويداي تتعرقان وروحي تتقلص في صدري، أنا قبل قليل كنت أعرف الإجابة، قبل أن يغزوني ذلك الارتباك الذي يعتصر رأسي. أرتجف… أتلعثم… ومن ثم أقف عاجزة عن الإجابة، ويأتي الحكم القاسي الذي حفظته ظهرعن قلب: ” استيعابك بطيء.. عقلك في مكان آخر”، كنت في كل درس أشعر أنني متهمة وسوف أُساق إلى قفص الاتهام. ما كان يقهرني ويؤلمني هو ضحكات زميلاتي الخافتة، ونظراتهن الاستعلائية أمامي، كانت أشبه بوخزات الإبر، كنت أخفض رأسي، وأتنفس بصعوبة محاولة إخفاء ارتجاف قلبي. آه… لو أنهم يرين ما يجري هنا داخل رأسي. ” كم تمنيت ترتيب الفوضى فيه كما يرتبن دفاترهن”.

في البيت، كانت كلمات أهلي تفعل فيّ أكثر مما يفعله القصف البعيد، ذلك القصف كان يأتي من خارج البيت، أما كلماتهم فكانت كالسكين تنغرس في داخلي: (أنت أغبى أولادنا…لماذا متخلفة عنهم في المدرسة؟).
” أنا متعبة.. هل تفهمون؟”.
” قلبي يتعب قبل عقلي، وعندما تخافون أنتم من الغد..أخاف أنا من اليوم نفسه”.
كنت أمام ذلك أجد الكتابة هي مساحتي الأخيرة….أفتح دفتري، وأكتب إزاء كل موقف (أنا لست غبية…أنا احب المدرسة وسأتفوق بها).
“(أنا لست غبية …أنا فقط أتوه قليلاً ).
أتخيل المعلمة طرحت عليّ السؤال الذي لم يخطر في بالها أن تطرحه عليّ، وأقول لها: (أنا خائفة يا معلمتي..أنا لستُ المشكلة، الظروف هي المشكلة).
(أنا لست غبية.. خوفي أكبر مني… أنا سأصير أكبر منه).
كنت أصنع من دفتري قرطاساً ألف به ضعفي وانكساري. هي جمل صغيرة وكلمات فحسب، كلمات ربما لا تعبر عن كل شيء، رغم أنها كانت تهذب كل اعوجاج داخلي… لكني كنت أحاول، كي تتوازن الأشياء عندي، وتبدو الظروف أقل تعباً وعبأً، وبعد كل هذه السنين لا زلت تلك الفتاة التي لا تستطيع إلا أن تقول: (أحب أبي.. أبي رجل طيب ) … في دفتري استطعت دفن الصدمات، وخلق فتاة صغيرة، تمردت على الرعب والتعنيف بالكتابة.
*إعداد: دلال ابراهيم.
حملة (مدرسة بلا عنف… بيئة بلا خوف).