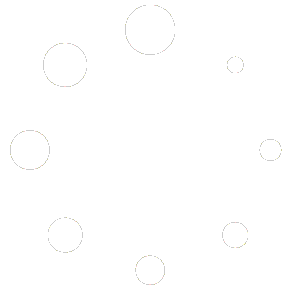تسترت على قصتي وكنت أظن هذا هو الصواب
خلال بحثي في اليوتيوب، وأنا التي أدمنته، وهجرت كل وسائل التواصل، عن برنامج أتابعه، وقع بين يدي فيديو عن امرأة تحاول الامساك وهي تصرخ برجل، بينما هو يحاول الإفلات منها، شدّني هذا الفيديو، ودفعني فضولي للبحث في أسباب صراخ هذه المرأة، ومحاولات الرجل المستميتة للإفلات والهروب منها .
بالبحث فهمت أن هذه المرأة الشجاعة، أمسكت هذا الرجل في مدخل البناية، وهو يشرع في الاعتداء على طفلة صغيرة، وبالتأكيد هي التي قامت بنشر هذا الفيديو الذي سجلته كاميرا البناية وفضحه، فقد كان وجهه واضحاً، وبإمكان أي أحد التعرف عليه.
في تلك اللحظة، كان أكثر ما يهمني هو البحث عن تلك الطفلة، كم تمنيت لو كشفت لنا الكاميرا ماذا كان يجري مع تلك الطفلة باللحظة تلك، هل كان هناك من يحتضنها؟ يسألها إن كانت بخير.. يطمئنها أنها بخير ؟
أتخيلها منزوية، تضم رجليها إلى يديها، ورأسها مطأطأ، تملأ عينيها الدموع، ويستولي الخوف على أنحاء جسدها المرتجف، ولا تفهم مما جرى إلا ذنبها.
كم تحتاج هذه الطفلة إلى من يحضنها بقوة، ويطمئنها أنها الضحية، ولا يجب أن تجلد نفسها لما اقترفه منحرف.
أخذني المشهد إلى أعماق الذاكرة، إلى تلك الطفلة التي انزوت داخل نفسها إلى الأبد، لا تفهم ولا تعي ما الذي جرى بالفعل، كم مرة جرى هكذا فعل من قبل، وكم مرة سيجري، إلى أن تعِ ما الذي يجري لتفجر غضبها على العالم .
توقفت عند تلك الطفلة التي كنتها قبل 45 عاماً، يا إلهي كم تبقى الطفولة بداخلنا مهما كبرنا! تبقى بكل أشكالها إلى أن نكبر، ونقرر حينها ماذا نستطيع أن نخرج من خزائن الذاكرة، وما الذي يحتاج إلى دفنه للأبد، ولكن ما أظن أننا قادرون على دفن أي منها، فما تلبث أن تخترق أجواء دواخلنا السحيقة، كل مرة تدق الأحداث الخارجية باب عقولنا، بما يبدو أنه لا علاقة لنا به.
نعم كنت أظن أنني تغلبت على تلك الذكريات،ولكن عندما رأيت هذا المشهد، وجدتُ نفسي اركض نحو تلك الطفلة التي كنتها، تلك الطفلة التي لم تغادرني . في تلك الأثناء، كم كان يسعدني حينما تطلب أمي مني أن أذهب إلى بقالية تقع أسفل بنايتنا، لأشتري لها غرضاً احتاجته فجأة، أهرول مسرعة لأنني استطيع الحصول على بعض السكاكر بالمقابل، كنت ممتلئة نشاطاً وحيوية مثل أطفال أفلام الكرتون.
المكان بنظر الأهل آمن جداً، مسافات قصيرة تفصل بين البيت والدكان، ولا خطر من سيارات مسرعة، صاحب الدكان رجل طاعن في السن، ودكانه مجاور لمنزله، بل هو غرفة اقتطعها من منزله، وعمل منها دكان يعتاش منه، ولكن في أكثر الأماكن أماناً يقع الخطر.
لا زلت استصعب استذكار تلك المرات، التي حاول فيها جارنا الهرم هذا استدراجي إلى خلف الطاولة التي كان يجلس خلفها، يجلسني على ركبتيه ليعطيني الحلوى، أو يشرط قبل أن يبيعني القدوم نحوه ليعطيني قبلة، كان في عمر جدي، حتى جاء ذلك اليوم الذي أنزل فيه سحاب بنطلون،ه وأراني عضوه الذكري، جملة لا زلت أذكرها، تفوّهت بها، أنهت هذا المشهد، بكل عفوية وبراءة الأطفال، قلت له : ستأتي الحاجة زوجتك وترانا.
حينها حسمت أمري بعدم الذهاب أبداً إلى تلك الدكان، ولكن عدم الانصياع إلى أوامر أمي، معناه إعطاء المهمة إلى إحدى أخواتي، وكنت في رعب أن يفعل بهم ما كان يفعله معي، اخترعت وكوني الكبيرة حجة لكي تذهب أكثر من واحدة إلى دكانه كي لا يستفرد بإحداهن، مضت طفولتي، وأنا أتجنب الذهاب إلى تلك الدكان، أو المرور من جانبها، حتى كنتّ أتعمّد قطع الشارع، والسير في الجهة المقابلة، تجنباً للمرور من أمامه.
كان خبر سماع وفاته بعد سنوات كثيرة تفصلني عن تلك الطفولة، خبراً جميلاً هللت له، وفيما بعد وكنت عندما أمر بالقرب من ذلك المكان، وقد ابتلعت العمارات الحديثة الدكان، أشعر براحة كشعور المظلوم بمعاقبة الظالم .
لم استطع البتة الحديث عن هذا الموضوع على مدار عمري، وفي كل مرة كنت أحاول إخراج الحادثة واختراق حواجزي الذاتية، كنتُ أجد نفسي داخل دوامة من العيب، والممنوع، واللوم، وتحمل المسؤولية، فأعيد القصة إلى الزاوية المنزوية فيها بداخلي، وأغلق عليها.
كبرت وصرت مراهقة، وفي إحدى زيارتنا العائلية مع أمي، وإذ بأحاديث يملؤها الهمس، والهلع، والخوف، والدعوة الصارمة إلى السكوت، لأن فتاة تعرضت لاعتداء من صاحب دكان شاب ربما أو هرم، كانت بعمر تلك الطفلة في الفيديوالذي شاهدته، وكانت بعمر الطفلة التي كنتها.
في البداية شعرت بالراحة، لأن الأمر تم اكتشافه، وتم احتواء الطفلة، وتدخلت العائلة بالأمر، وكان التستر هو القرار الصائب للجميع، وعندما سألت أمي لماذا قالت: لأنهم خائفين على سمعة الطفلة عندما تكبر.
تلك الحادثة، أكدّت لي أن إخفاء جريمتي، أو الإجرام الذي لحق بي كان صواباً، فلقد عشت طيلة تلك السنوات، وأنا أُجرّم نفسي على ما كان ذلك الهرم على وشك القيام به، والحقيقة أنه لم يحصل أي شيء أكثر مما ذكرته، ولكن كان يُمكن أن يحدث لو لم أقل له أن زوجته قد تأتي، هو ما عاقبت عليه نفسي دوماً بلوم وجلد لم يتوقف، وفي كل مرة كنت أحاول الحديث عن الحادثة، كنت أتراجع لأن التستر هو المطلوب.
كبرت، وخرجت تلك الحادثة من داخلي إلى العلن، وصرت أتداولها بحذر، وبضحك مع الجميع، ليتبين أن ذلك الرجل كان متحرشاً بالجميع، ولكننا جميعنا تسترنا لخوفنا من أننا كنا مسؤولات عن ذلك الفعل معه.
كانت أكبرنا لا تتجاوز الست سنوات، وحملنا كل تلك السنين، وزر فعل رجل كان بالستين من عمره، وبالتأكيد لم يفكر أبداً أن ما كان يقترفه من انحراف بالأمر الغريب، فكان الرجل يجلسني والأطفال الآخرين في حضنه أمام زوجته، التي تأتي مداعبة بحنان الجدة، تسألنا عن أمهاتنا، ويبدو لكل من يراه بأنه ذاك الجد الحنون.
صحيح أن تلك الحوادث تنتهي، ولكن أثرها لا ينتهي، ولا يزول الألم المصاحب له في نفوسنا مهما مر عليه الزمن، إذ وبينما يلتم الناس، وتنشغل بتلك الطفلة، يخافون ويرتعبون لحمايتها، والتأكّد من سلامتها، يكون الأثر قد اخترق وجدانها. وبدلاً من طمأنتها، والحديث معها، ومعاقبة المنحرف ومحاسبته، يتم معالجة الموضوع بالتستر، وتكبر تلك الطفلة، ومهما بدا عليها من قوةٍ وصلابة، يبقى بداخلها أثر جرح تسبب بالتشوه لروحها، ويستمر المنحرف بانحرافه، والتسبب بجروح لآخريات، ويتم التستر عليه، ويستمر العبث بأرواح الأطفال، ويشوه الطفولة التي ينطفىء ربيعها إلى الأبد، مهما تبدلت المواسم.
*دلال ابراهيم.
تعقيب:
ثقافة العيب والتستر على الجناة، تقتل أرواح ملايين الأطفال، وتترك ندوباً لا تشفى أبداً، وتعاود الظهور لديهم مشاعر الألم والحيرة، والشعور بالذنب على أوزار لم يقترفوها، ولعل أخطر ما في ثقافة العيب من الإفصاح عما يتعرض له طفل ما، والتستر على الجاني، هو استمرار هذا الأخير في أذية أطفال آخرين، وبمنتهى البساطة لو تم وضع حد له، لتجنب عشرات وربما مئات الأطفال هذا الألم، وقد آن الأوان أن يتعامل مجتمعنا مع الجسد وثقافة الجسد برؤى واضحة وشفافة، لا تغلفها ثقافة العار والعيب، ومن المهم فضح الجناة، والتشهير بهم، لحماية الأطفال الأبرياء من الانتهاكات هذه، والحفاظ على براءتهم للمضي بحياتهم مع ألم أقل، لأن الحياة فيها ما يكفي من الآلام للكائن البشري، ولا تحتاج لأن نزيدها.