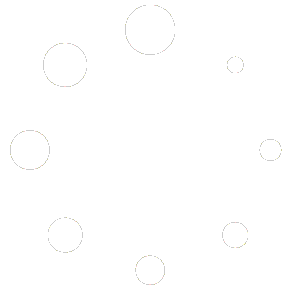من خلال تراكمات المعرفة لدي، والتي غالباً ما تكون منسية المصدر، تكوّنت عندي فكرة عن نظرة المجتمعات على مر التاريخ إلى العملية الجنسية غير المشرّعة، سواء المثلية منها، أو الغيرية، كفاعل ومفعول به، لا كفاعلَين شريكين في العملية ذاتها، وقد درجت العادة في مختلف المجتمعات على التغاضي عن الفاعل، وإدانة المفعول به وعقابه أشد العقاب، وهو ظلم مجتمعي ما بعده ظلم.
هذا في العمليات الكيفية بين بالغين، ثم ليشتد الظلم إلى أقصاه عند عمليات الاغتصاب، والتي يجب فعلياً تصنيفها كفاعل غالب ومفعول به مغلوب على أمره؛ فيدان المغلوب على أمره وتلحق به وصمة العار، بينما غالباً ما ينجو الفاعل الغالب!
وأما الظلم الذي يتجاوز الحدود إلى مالا يمكن وصفه، هو في الحالات التي يكون فيها المغتصَب/ة طفلاً، فعلى الرغم من أن المغتصِب قد يلقى عقاباً أو ملامة في مثل هذه الحالة، إلا أن المجتمع يتناسى فعلته مع مرور الوقت، بينما لا يُنسى أبداً ما حل بالضحية، بل وقد يفعل كل ما من شأنه تذكيرها (الضحية) بما ألم بها يوماً، مما يجعل معاناتها دائمة وأبدية.
مع تطور البشرية، فقد خفت كثيراً أو ربما انتهت هذه الحالة في بعض المجتمعات في العالم المعاصر؛ ليس مجتمعنا من بينها، فبقيت نظرة المجتمع إلى الجنس كعمل شائن يتحمل وزره المفعول به أكثر من الفاعل، هذا إن لم يُشَد بالفاعل مقابل احتقار المفعول به.
حتى أن الجنس تحول إلى وسيلة عقاب في مفهوم الشارع لدينا، فتجد أن الألسن الذكورية‘ وحتى الأنثوية في بعض الأحيان‘ تلهج بالتهديد باغتصاب الخصم، أو تحرّض عليه.
تلك الألسن لم تكتسب هذه المصطلحات من فراغ، إنّما هي ترجمة لاحتقارنا المتوارث للجنس عبر الأجيال.
أرى أن تلك المفاهيم سالفة الذكر، لها اليد الطولى في تكتم أهالي الضحايا عند وقوع حادثة التحرش أو الاغتصاب؛ ما استطاعوا إلى التكتم سبيلا، ما يسهل على الفاعل النجاة بفعلته في كثير من الحالات، دون الأخذ بعين الاعتبار ما ستعاني منه الضحية من شعور أليم بالغبن سيلازمها مدى الحياة.
ما يجعل الأمر أقسى وأمر، هو أن يكون المتحرش من ذوي القربى، إذ تكون أسباب التكتم بنظر الأهل مضاعفة، فهم يحسبون حساب سمعة العائلة بين الناس، ويحسبون حساب مشاعر أسرة المتحرش نفسه، ما يدفعهم ليس إلى التكتم فحسب، بل قد يصل بهم الأمر إلى تكذيب الضحية إن استطاعوا، ما يفقد الطفل /الضحية/ الثقة بأقرب الناس إليه كما روت السيدة (س).
تقول السيدة (س): أنها وعلى الرغم من بلوغها العقد الخامس، إلا أنها لا تستطيع نسيان محاولة اغتصابها من خالها، عندما كانا في الحادية عشر من عمرهما، وإنّها تستعيد موقف أمها وخالاتها، اللواتي أجبرنها على الصمت، دون أن يتخذن أي إجراء بحق شقيقهن، بذريعة حداثة سنه آنذاك، وكانت النتيجة أن الصبي المتحرّش قد أخبر رفاقه بما جرى مفاخراً، وأصبحت الطفلة محط سخرية الصبية في الحي، دون أن تجرؤ على إخبار أهلها بما تلاقيه من تنمّر وسخرية، نتيجة خذلانهم لها عندما لجأت إليهم.
تقول الضحية /س/:
لقد عشت الرعب على مدار سنوات، وخصوصاً عند زياراتنا إلى بيت جدي في عطلة الصيف، أو العطلة الانتصافية، حتى أنني كنت أنام مرتدية سروال الجنز مع الحزام، خشية أن يحاول تجريدي من ثيابي أثناء نوم.
*نتيجة إضافية لموقف الأهل، فإن الصبي شبّ على ما هو عليه من تدنٍ أخلاقي، حتى أنه جدد تحرشه بضحيته بعد أن كبرا، رغم أنها كانت متزوجة وقتها، مما رسخ لديها عدم الثقة بالبشر جميعاً على حد قولها، وساهم بعيشها بانطوائية دائمة، ونفور من المجتمع لم ينتهِ حتى يومنا هذا، بينما يعيش المتحرش حياة اجتماعية طبيعية، لا يعكر صفوها شيء.
إذا كان لي أن أبدي رأياً شخصياً، بمعزل عن آراء المختصين، فإنني أعتقد أن الإصلاح الجمعي للمفاهيم السائدة سيلزمه أجيال وأجيال، وعليه؛ فلا بدّ من إجراءات توعوية وتثقيفية مؤقتة على نطاق الأسرة، أو المجتمعات الصغيرة، كخطوة أولى على طريق الألف ميل.
*زيدون “زياد” الجندي.