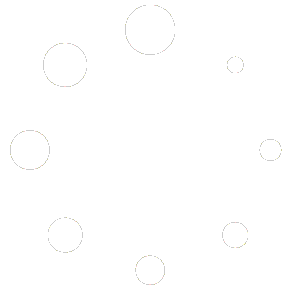تُشكل الإحصائيات والأرقام مؤشراً مهماً، على نسبة انتشار أي ظاهرة، ولا شك أن أي مراجعة لنسب انتشار ظواهر التحرش بالأطفال وتعرضهم للاغتصاب، والاعتداء الجنسي حول العالم، وفي بلادنا العربية على وجه الخصوص، ستكون صادمة جداً، لا لجهة ارتفاع النسب تلك فقط، بل لجهة التفاصيل والحيثيات الأخرى المرتبطة بها، من مثل: من هم المتحرشون بالأطفال، وأماكن تعرض الأطفال للتحرش، وتفاوت النسب بين الفتيات والفتيان، وغيرها من تفاصيل.
ومن الجدير بالذكر، أنه على مدى عقود من الزمن، كانت هذه الظاهرة الخطيرة، من الظواهر المسكوت عنها في مجتمعاتنا العربية، وعلى العموم
فإن الوعي بهذه الظاهرة وضرورة التخلص منها، آخذ بالازدياد، ومع ازدياد هذا الوعي بدأت العديد من المؤسسات الاجتماعية والقضائية، ومراكز البحوث التربوية، تنشر إحصائيات تبين درجة انتشارها، وبالرغم من ذلك لا بدّ من التأكيد أن الإحصائيات المنشورة على أهميتها، وأهمية دلالتها، فإنّها لا تُعبر بشكل حقيقي عن نسبة الانتشار، لأن الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، بسبب الثقافة الاجتماعية المحلية السائدة، وارتباط هذه الظاهرة بمفاهيم العار والفضيحة الاجتماعية، إضافة إلى التستر على العديد من الحالات عندما يكون المتحرش أحد أفراد العائلة أو الأقارب، أو من المقربين من عائلة الطفل الضحية.
من العوامل التي تجعل من الأرقام والإحصائيات مؤشرات غير كاملة الصدقية، للتعريف بمدى انتشار ظاهرة التحرش بالأطفال، هو ما يؤكّده المتخصصون، وما هو واقعي بالفعل، بأن حالات التحرش بالأطفال لا يُمكن اكتشافها ومعرفتها إلا بعد اعتراف الأطفال بما تعرضوا له، وهذا يجعلنا نفكر تلقائياً بأن هناك آلاف الأطفال، وربما الملايين قد تعرضوا لنوع من أنواع الاعتداءات، ولم يبوحوا بها، بسبب عدم وعيهم الكامل بضرورة التحدث، وعدم فهمهم لما يجري، أو تجنباً للشعور بالعار، أو الخوف من الفضيحة، أو الخجل، أو بسبب طبيعة الظروف المحيطة بالطفل وعائلته، أو تجنباً للجرح النرجسي الذي سببته لهم، وشعورهم بالضعف لعدم إمكانيتهم الدفاع عن أنفسهم، عدا عن حالات عديدة من الإعاقات الجسدية والدماغية، والتي تحرم بعض الأطفال من القدرة على البوح
من المهم جداً للباحثين، والمعنيين بشؤون الطفل، والعاملين على قضايا حقوقه ومتطلباته، أن يأخذوا بعين الاعتبار كل النقاط المذكورة سابقاً، عند التعامل مع الأرقام والإحصائيات، فمهما كانت دلالاتها ومؤشراتها، مهمة وخطيرة، فإنه دائماً يبقى الأهم هو ما وراءها، وما لم يُقال أو يُدون أو يُشار إليه، وخاصة في البلاد العربية، والبيئات المحلية المنغلقة على نفسها، والتي ما زال فيها للعرف والتقاليد أهمية كبرى، ولربما كان من الضرري جداً، القيام بعمليات التوعية في هذه البيئات، وبأساليب وطرق تتناسب مع درجة وعي الناس، وعبر مداخل تجعلهم يستشعرون من خلالها خطورة هذه الظاهرة، وضرورة الحديث عنها مع أطفالهم، ورفع مستوى الحماية لهم.