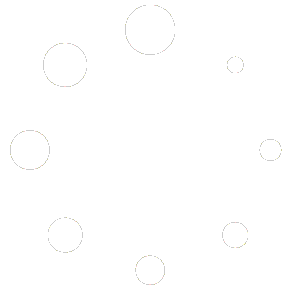* الله صوت الضمير في الإنسان، وفي الطفل يتجلى هذا الصوت في أبهى معانيه
إن التركيز على الفوز، والتفوق الذي يحرزه الطفل والناشىء في بعض الرياضات، يكمن خلفه الكثير من المآسي، والمعاناة التي يحملها أطفالنا بين حنايا أجسادهم الغضة، وفي أرواحهم المسحوقة، وحتى عندما تتكشف بعض جوانب تلك المعاناة، كما في جرائم الاعتداء الجنسي من تحرش، واغتصاب…وغيرها من انتهاكات خطيرة، يُسارع الجميع للحديث عن التعافي، وعن رحلة العلاج، وهنا يتبادر إلى الذهن العديد من الأسئلة، ولعلّ أبرزها:
هل العلاج النفسي بعد مدة من حادثة الاغتصاب، كافٍ لإزالة الألم والقهر النفسي لدى الضحايا، وخاصة أنه لا مكان للمغتصب في زنزانة، أو تحت ضغط أي عقاب، فغالباً هو يمارس حياته بكل جوانبها، وبسقوط أخلاقي مريع، وكأنّ شيئاً لم يكن، مما يولّد لدى الضحايا كم كبير من الاستفزاز المؤذي.
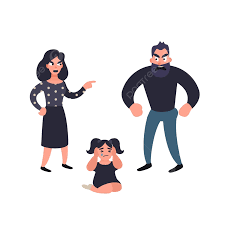
الأهل، أسرة الطفل، هم الركيزة الأساسية لاستعادة حقوقه، وتقويته نفسياً، واجتماعياً، وتحصينه من داخله، إلى درجة يستطيع أن يتغلب على تلك المُعاناة، ويمسك بيد من تعرضوا لما تعرض له ويتعاطف معهم، وعايشوا الحالة ذاتها التي مر فيها، إلا أن الانتكاس النفسي الأساسي ،يعود أولاً وأخيراً، عند سماح الأهل للآخرين بأذية الطفل، تحت مبرر العيب والفضيحة ووصمة العار… وغيرها، وهذا كله يندرج تحت بنود السقوط الإنساني إلى درك من الانحطاط وانحدار القيم الأخلاقية للمجتمع، وتصبح الفوارق الاجتماعية هي الحاكم والحكم، وخاصة ما ارتبط منها بالعوز، والفقر، والانكسار النفسي، فها هنا لا وجود أو حضور لأي حق من حقوق الطفل، وغالباً ما نجد ذلك يتكرر بكثرة في قطاع الرياضة، فالكثير من الأطفال، والقادمين من بيئات فقيرة، وشبه معدمة، يسكتون على انتهاكات مريعة يتعرضون لها، على أمل أن يُشكّل نجاحهم في رياضتهم دفة الخلاص لهم، ولعائلاتهم لتغيير حياتهم للأفضل، ولذلك عندما يتمادى المدربون، ويتطاول أفراد الكادر الفني للنادي، وينتهكون الطفل ويسيئون معاملته، فهم بهذا الفعل لا ينتهكون جسده الصغير فقط، وإنما ينتهكون روحه، ويعتدون على طموحه، وآماله في حياة أفضل له ولعائلته، وفي هذا ذنب لا يغتفر، فكما تُنتهك الأجساد والأبدان، فها هنا تُنتهك الأرواح، والنفوس، والطموحات والآمال، وكم من حادثة وجريمة بحق الأطفال في قطاعات الرياضة المختلفة، دمرّت حياة شباب وشابات، وعائلات بكاملها، بينما واجه بعضهم/ن بشجاعة، متحملين كل التبعات والآثار الناجمة عن ذلك، لكن بقيت أرواحهم مسحوقة، ونفوسهم مكسورة، تحت ألم ما عاشوه، وما تعرضوا له.
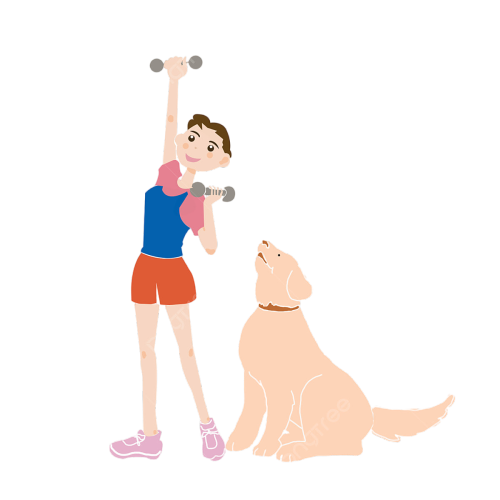
الطفل هبة السماء وهدية الله، ولا شيء يتمحور حول أي أهمية في هذه الحياة، أكثر من تنشئته تنشئة متوازنة، في بيئة تستطيع على الأقل الدفاع عن حقوقه، وحمايته.
لماذا الخوف وممن؟
طالما هذا الطفل هو الجسر الأهم في الوصول إلى المجتمعات التي تنتج وتعمل، وترتقي، فلماذا الخوف والتفريط في المستقبل على هذه الصورة؟
قد يصبح بعض الضحايا، إذا ما افتقدوا الدعم والمساندة، مشتتين، بين خفايا أنفسهم وانتكاساتها، والعديد منهم أصبحوا ضحايا وحوش متجدّدة، مثل تعاطي المخدرات، وإدمان الخمور والمهدئات … وغيرها، ومنهم أصبحوا يلعبون الدور نفسه الذي تمت ممارسته عليهم، لتعزيز القوة بداخلهم، وربما هناك محاولة لإقناع أنفسهم بأنهم قد نجوا وتعافوا من آثار الاعتداء، وللأسف هم/ن في خضم قوة قد تتحول شيئاً فشيئاً إلى قوة تسلطية، خطيرة على كل من حولها، وهكذا يُساهم المجتمع نفسه في صنع الوحوش التي تلتهمه، في دورة حياة مرعبة، ومؤلمة، ولا إنسانية.

بالحب، والحنان والاحتواء، نستطيع تجنب كوارث كبيرة، فإن لم تُتاح إدانة المغتصب بشكل مباشر، فعلى الأقل يجب احتضان الضحية، وتحويلها من ضحية إلى ناجية تستحق الحياة، بأمان وسلام، وهذا أول ما يجب على المجتمع فعله، وخاصة من قبل هؤلاء المؤمنون الكثر في مجتمعاتنا، فنحن أكثر المجتمعات على كوكب الأرض حديث عن الإيمان بالله، ولكن الإيمان بالله باطل، طالما هناك تواطؤ أخلاقي ضد الطفل، من قبل أسرته وغيرها من أطراف، لأن الله صوت الضمير في الإنسان، وفي الطفل يتجلى هذا الصوت في أبهى معانيه، فما بالكم من بعدها!
*إعداد: مايا سمعان، محررة في الفريق الإعلامي لمؤسسة نداء.
*مراجعة: خولة حسن الحديد.