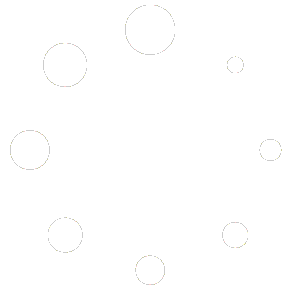مقدمة:
حين تصادفنا المشاكل والمعضلات ونعمل على حلها، فغالباً ولكي نصل لفهم صحيح برأيي، على أقل تقدير علينا ما يلي:
أولاً: الاعتراف بوجود المشكلة، وعدم التهرب أو التبرير.
ثانياً: المحاولة بالرجوع لأصل المشكلة.
ثالثاً: محاولة فهم الأسباب والمنحنيات الزمنية، التي خلقت بتراكمها مشكلة متأصّلة.
التحرش، أو الاعتداء الجنسي على حدٍّ سواء، هي مشكلة حقيقية نُعاني منها في يومنا هذا، ولا أعتقد أنه لم يتعرض أحدنا لنوع من أنواع التحرش والاعتداء، أو سمع، أو ربما كان شاهداً على حادثة ما.
إذاً هل هي ظاهرة حديثة؟! أم أنها كانت موجودة بعصور سابقة، وماهي نظرة المجتمع في الماضي، وكيف كان التعاطي معها؟!.
-الهدف من هذه السلسلة، هو تسليط الضوء على أسلوب تعاطي أسلافنا مع البيدوفيليا، ومدى انتشارها وتقبّلها، ومحاولة الوصول لبعض الإجابات، وفهم الأسباب الرئيسية والثانوية، التي ساعدت أو مهدت الطريق للعقل اللاواعي بقبول أو تقبل الشذوذ، ومنه الوصول للتحرش والاعتداء الجنسي بأنواعه.
لن أتبع التسلسل التاريخي في ذكر المراحل، بل ستكون الأسبقية لما هو أقرب لمجتمعنا، وبعدها يكون التوسع أكثر من حيث الزمان والمكان، على حسب الانتشار والأهمية.
لايوجد تاريخ محدد لنشأة البيدوفيليا “كفعل”، فقد وجد العديد من الرسوم والنقوش والكتابات عند: الإغريق، الفراعنة، الرومان، الفُرس، الصين القديمة، اليونان والعرب، كلها تدلُّ على وجود هذا النوع من الممارسات.
* تنويه مهم:
نحن في مؤسسة “نداء”، سنتعامل مع كل الأحداث والمعطيات بكل موضوعية، وكل ماسيتم ذكره بهذه السلسلة، ليس الهدف منه التهجم نهائياً، لا على ديانة أو معتقد، ولا أشخاص ولا إرث أو تاريخ، نحترم الجميع بكافة ألوانهم واختلافهم، والتركيز على هذه الظاهرة، لايعني الفساد الكامل، بل هي جزئية فاسدة ذات أثر كبير على حاضرنا ومستقبلنا.
ج1 “لمحة عن البيدوفيليا في تاريخ العرب”
انتشرت البيدوفيليا في الجغرافية العربية منذ القدم، ووصلت لذروتها بالعصر العباسي، والذي كان له الحصة الأكبر، قبل العودة لانحسارها تدريجياً، ولكنها لم تنتهي تماماً، فمازال هذا الميول منتشر إلى يومنا هذا.
حظي الغلمان بمكانةٍ عظيمة في قصور الخلفاء والأمراء، وكما كانت عادة العرب بفصاحتهم، واستخدامهم الشعر للتعبير عن حالهم وترحالهم، فقد وصَلنا منهم عدد كبير من الأبيات الشعرية التي تعكس انتشار تلك الظاهرة، وأصبح هناك نوع خاص من أنواع الرثاء، وهو رثاء الجواري والغلمان، ومِن أشهر مَن تحدث عن الرثاء هم: الشاعر أبو نواس، والشاعر مسلم بن الوليد، والحسين بن الضحاك، بالإضافة لـ: بشار بن برد، مطيع بن إياس، يحيى بن زياد، حماد عجرد، سلم الخاسر، والبة بن الحباب وإبان اللاحقي، وغيرهم.
ويقول ابن أبي البغل:
وإلا فالصغار ألذ طعماً…وأحلى إن أردت بهم فعلاً.
والشعر كذلك لم يكن حكراً على الشعراء فقط، بل كان نطقاً شائعاً عند العامة والخاصة.
يروي الطبري في تاريخه، أن الخليفة العباسي “الأمين” طلب الخصيان، وابتاعهم، وغالى بهم، وصيّرهم لخلوته في ليله ونهاره، ورفض النساء الحرائر والإماء. ويُروى أن والدته حاولت ثنيه عن عادته هذه، فأتت له بفتيات (يتشبّهن الغلمان) دون أن تنجح في مسعاها، وكان للخليفة غلام تعلق به فؤاده، ويُدعى“كوثر”، نَظم فيه شعراً، فقال:
كوثـر ديني ودنياي وسقـمي وطبيبي
أعجز الناس الذي يلحي مُحباً في حبيبِ.
وهنا يتضّح لنا مدى توغل الشذوذ الجنسي في بلاط الخليفة، فكانت النساء تتشبّهن بالغلمان لإثارة الرجال جنسياً، وهذا التوغل له انعكاس كبير على المدى البعيد، في تعزيز وانتشار البيدوفيليا.
*تعريف الغلام كما جاء في معجم المعاني الجامع:
الجمع : أغْلِمَة و غِلمان و غِلْمة.
الغُلامُ: صبيُّ حين يولد إلى أن يَشبّ أو حين يقارب سنَّ البلوغ، ويطلق على الرَّجُل مجازاً.
كذلك كان الخليفة الأموي “الوليد بن يزيد بن عبد الملك”، محباً لمضاجعة الغلمان، حتى أنه بيوم راود أخاه عن نفسه، ذلك لأنه كان إلى جانب شهوته للجواري يشتهي الغلمان.
وكان للخليفة العباسي “الواثق” غلام وعشيق اسمه “مهج”، كتب فيه الغزل، فكان الوزراء وكبار رجال الدولة يتوسطون بـ “مهج”، لدى الخليفة لقضاء شؤونهم وشؤون الرعية!
والخليفة “المتوكل” أيضاً قد امتلك عشيقاً اسمه “شاهك”.
يروي المسعودي في كتابه “مروج الذهب” أن الخليفة “المعتصم”، كان يحب جمع الأتراك وشرائهم من أيدي مواليهم، (فاجتمع له منهم أربعة آلاف، فألبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة).
وهنا يحضرني بيت شعر لـ “ابن التعاويذي” يقول به:
إذا كان رب البيت بالدف ضارباً .. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
فلم يكن العلماء، والأدباء، والكتّاب وغيرهم بمنأى عن هذا الخلل، وسأتطرق لبعضهم بشكل مختصر، منهم:
أبو عبيدة النحوي البصري، والكسائي النحوي.
ومن القضاة: كان يحيى بن أكثم قاضي البصرة، والقاضي الجرجاني المشهور، وكان الجرجاني صديقاً للوزير الأديب “الصاحب بن عباد” ومقرّباً منه، الذي اشتهر هو الآخر بتلك العادة، والصاحب بن عباد يفتنه أحد غلمانه بغنجه، ولثغته، فيقول فيه:
وشادن قلت له : ما اسمك؟ فقال لي بالغنج عباث
فصرت من لثغته ألثغا فقلت: أين الكاث والطاث.
وهنا يجب التنويه على أن الشذوذ الحاصل في بعض العصور، أو لسنوات محددة كان عاماً شاملاً، ولم يكن في دائرة التحرش والاعتداء الجنسي فقط، ولكن وجب ذكر هذه التصرفات لأنها مرتبطة بعمق بمشكلتنا، فالخلل “الأخلاقي” يعم، ويُحفّز على كل التصرفات الشاذة والاعتداءات، فهذا الخلل الحاصل ساعد على انتشار البيدوفيليا بين الناس، ليس بسبب اقتناعهم بالفعل ذاته، بل لأنه كان ممارس من قبل الطبقات الحاكمة و الارستقراطية، وأغلب الشعراء كانوا جُلساء الأمراء والملوك، وكانوا يتودّدون إليهم بالشعر، وهذا مازاد من جرأتهم بترويجه، وبشذوذهم كذلك.
الميول الجنسبة الطبيعية للبشرية هي واضحة بأسُسِها، ولكنها متغيرة على المستوى الفردي، وهذا يحصل ويمكن احتواؤه، أما التغير بهذه الأسس على مستوى القبول العام، أو بشكل أدق بعدم المجاهرة بالرفض، فهذا يؤدي إلى تأصيل الخلل واستمراره، وانتقاله من جيل إلى جيل، فحين يكون أصل الخلل عند من بيده الحكم، فهذا يساعد بتقبل الأمر جهراً من بعض الناس، ورفضه (ضمناً) من بعضهم الآخر، ويعود السبب بالرفض هنا للسوية الفكرية الفردية، والتي تكون هي الرادع الوحيد للإنسان عن الاعتداءات والشذوذ.
كل فساد يجتر معه فسادٌ آخر، وكل خلل يؤدي إلى خلل أوسع، بدليل ماحصل من تفكك وانهيار للممالك بعد دخولها فترة الانحطاط، فلم تسقط تلك الممالك بفعل الحروب، ولا بفعل ظواهر طبيعية، فأسباب سقوطها الأساسي، كان نخر “سوسة” الفساد والانحراف لمفاصلها وأسسها، حين يأكل الخلل عصب الدولة: (الإنسان)، فمصيرها الخراب حتماً، فكيف لو أنه ابتلع بدايةً حكامها وحكمائها؟!
*محمود عبود